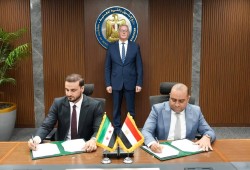قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن قرار رفع أسعار خدمات المحمول ما يزال قيد الدراسة، وإنه يستهدف إتمام 3 آلاف برج خلال 2026 لرفع كفاءة الخدمة. هذه الصيغة المزدوجة—وعود بتحسين الشبكات مع تلويح بزيادة الأسعار تعيد طرح السؤال الأهم: من يدفع كلفة فشل الإدارة وتدهور الخدمة في ظل حكومة الانقلاب؟ “قيد الدراسة” أم تمهيد للزيادة؟ إعلان أن رفع الأسعار ما يزال “قيد الدراسة” يمنح الحكومة مساحة مناورة لتهيئة الرأي العام تدريجيًا، خصوصًا في ظل موجات الغلاء التي أضعفت قدرة الأسر على تحمل أي أعباء إضافية. في العادة، لا تأتي زيادات الاتصالات بمعزل عن منطق “الجباية” الذي صار السمة الأوضح للسياسات العامة: تحميل المواطن فاتورة الاختلالات بدل إصلاح جذورها، ثم تقديم الزيادة باعتبارها “ضرورة لتحسين الخدمة”. المشكلة هنا ليست في مبدأ تطوير البنية التحتية نفسه، بل في غياب الشفافية: ما هي معايير التسعير العادل؟ وما حجم التكاليف الفعلية على الشركات؟ وما الذي يضمن أن الزيادة—إن حدثت—ستنعكس على جودة الخدمة لا على الأرباح فقط؟ 3 آلاف برج.. وعد تقني أم غطاء سياسي؟ ربط الحديث عن الأسعار بخطة إنشاء 3 آلاف برج خلال 2026 يقدم صورة مُطمئنة ظاهريًا: الدولة “تعمل” وتستثمر في الشبكات، ومن ثم تبرر أي تعديل سعري باعتباره جزءًا من حزمة إصلاح. لكن التجربة المصرية في ظل حكومة الانقلاب علمت الناس أن الأرقام الكبيرة كثيرًا ما تُستخدم كستار إعلامي، بينما يبقى معيار المواطن بسيطًا ومباشرًا: هل ستتحسن التغطية فعلًا؟ هل ستنخفض الشكاوى؟ هل سيتوقف انقطاع الخدمة وضعف الإنترنت داخل المدن وخارجها؟ ثم إن توسعة الأبراج ليست مجرد قرار فني؛ هي ملف يرتبط بتراخيص ومحليات وأراضٍ وتنسيق مع جهات متعددة، ما يعني أن “الإنجاز” ليس مضمونًا بمجرد إعلان النوايا. وعندما تتأخر النتائج، يبقى المواطن محاصرًا: خدمة متعبة وسعر أعلى. من يدفع ثمن “التحسين”؟ جوهر الأزمة أن حكومة الانقلاب تدير الخدمات الأساسية بمنطق السوق عندما يتعلق الأمر بالمواطن، وبمنطق الامتيازات عندما يتعلق الأمر بمراكز القوة. المواطن يُطلب منه التحمل باسم الإصلاح، بينما لا تُفتح ملفات الكفاءة والحوكمة والرقابة بالجدية نفسها. رفع أسعار المحمول ليس تفصيلًا هامشيًا؛ الاتصالات اليوم جزء من الحياة اليومية والعمل والتعليم والخدمات البنكية والتحويلات، أي أن أي زيادة تتحول عمليًا إلى “ضريبة غير مباشرة” على ملايين الناس، خصوصًا أصحاب الدخول الثابتة والعمالة غير المنتظمة. وفي مناخ اقتصادي يضغط على الطبقة الوسطى ويفقر شرائح أوسع، تصبح الزيادة المحتملة رسالة سياسية بقدر ما هي قرار تنظيمي: الدولة لا ترى المواطن شريكًا في الخدمة، بل ممولًا دائمًا للعجز وسوء الإدارة. الأخطر أن غياب المنافسة الحقيقية والرقابة الفعالة على جودة الخدمة يخلق معادلة مختلة: يدفع المستخدم أكثر، دون ضمانات ملزمة بتحسن ملموس، ودون آليات تعويض واضحة عند تدهور الأداء. واخيرا فان التصريح “قيد الدراسة” حول رفع أسعار المحمول، مع وعد بإتمام 3 آلاف برج في 2026، يكشف نهجًا متكررًا: تسويق الزيادة باعتبارها ثمن التطوير، بدل أن يكون التطوير حقًا أصيلًا ممولًا بعدالة وكفاءة وشفافية. في دولة تُدار بعقلية السيطرة لا المحاسبة، لا تُقاس السياسات بما تحققه من عدالة وجودة، بل بما توفره من سيولة وهدوء مؤقت حتى لو كان الثمن مزيدًا من الضغط على الناس. وإذا كانت الحكومة جادة فعلًا، فالمطلوب ليس خطابات عامة عن “رفع الكفاءة”، بل التزامات مكتوبة قابلة للقياس: مؤشرات جودة منشورة، جداول زمنية معلنة، وقواعد واضحة تربط أي تعديل سعري بتحسن فعلي يشعر به المواطن لا بوعود تتكرر كل عام.
الأربعاء 18 رجب 1447 هـ - 7 يناير 2026
أخبار النافذة
مجلس الوزراء: سحب منتجات حليب الأطفال "نستله" بسبب اكتشاف مادة سامة
إعادة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي بعد سقوط منصة «كيريو».. ارتباك تقني يربك طلاب الصف الأول الثانوي
"7 يناير" ذكرى استشهاد سليمان خاطر لأجل حدود وطنه التي فرط السيسي بها
أجساد تحت النار.. الاغتصاب الجماعي والقصف والمسيّرات والأوبئة ترسم ملامح الكارثة الإنسانية الأكبر في السودان
ردم ترعة "الشيخ زايد" يُبوّر 57 ألف فدان في العلمين والضبعة لصالح "جمهورية الكومباوندات"
غزة تحت النار والمرض معًا.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي وانهيار صحي يهدد حياة الآلاف
بين الاهمال وسوء الإدارة.. تضارب الروايات حول وفاة مريض داخل مستشفى بـ6 أكتوبر
جرينلاند تحت أطماع أمريكا: كيف أعاد ترامب منطق الاستعمار إلى قلب النظام الدولي؟