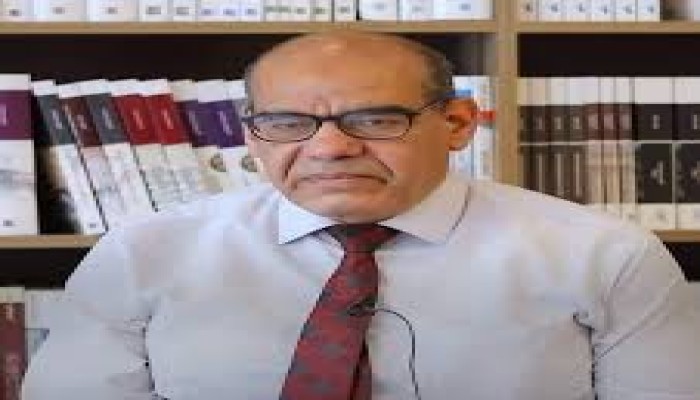د. خيري عمر
أستاذ العلوم السياسية في جامعة صقريا
بينما تسبّبت حدّة الانقسامات الدولية في إفشال قمّة القاهرة للسلام (21/10/2023، يمثّل التوصّل إلى اتفاق السلام في "قمّة شرم الشيخ للسلام" (13/10/2025) نقلة نوعية في أداء السياسة المصرية بالتوصّل إلى "اتفاق إنهاء الحرب في غزّة". وذلك من وجهة الاستمرار في العمل وفق الموازنة ما بين الدور الفردي والعمل الجماعي، وخصوصًا ما يرتبط بالمساهمة في صياغة المُحتوى السياسي لشروط وقف الحرب ومدى الالتزام به. وهنا، تبدو أهمية تناول ملامح اختيار السياسات، وقدرة السياسة الخارجية على التكيّف مع التغيّرات المُصاحبة للحرب في ضوء ميراث التعامل على القضية الفلسطينية.
في وقتٍ مبكّر، وضع بيان مجلس الأمن القومي، 15 أكتوبر 2023، الملامح العامة للسياسة المصرية تجاه الحرب في غزّة، حيث قاعدتان: الأولى، العمل مع الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية لخفض التصعيد وإنفاذ المساعدات. والثانية، رفض تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير من قطاع غزة إلى دول الجوار، وهو ما يمثّل تجاوزًا لحل الدولتين. فيما كانت الثالثة ماثلة في تحديد دور مصر في التهدئة واستئناف عملية السلام.
شكّلت هذه الأرضية قلب السياسة المصرية تجاه الحرب في غزّة، وقد انعكست مفرداتها في الحوارات مع المسؤولين الأجانب، كما كانت أساس الدعوة إلى انعقاد "قمّة القاهرة للسلام" في 21 أكتوبر 2023. وذلك بالإضافة إلى اقتراح مبادرات الوساطة على مدى العامين اللاحقين وحتى انعقاد "قمّة شرم الشيخ" في 13 أكتوبر 2025.
وفق هذا التوجّه، صاغت السياسة المصرية أهدافها لخدمة محورين أساسيين؛ منع التهجير ووقف الحرب. جاء مستقبل القضية الفلسطينية في أولوية الاهتمام. وفي هذا السياق، اتبعت مصر ثلاث سياسات، كانت الأولى في ضروريّة استمرار الوساطة لاحتواء وقف إطلاق النار. على مدى الفترة، انشغلت مصر ببناء الثقة، فقد حرصت على تلازم إجراءات الانسحاب ووقف النار. وفي هذا السياق، شكّلت المبادرة المصرية في ديسمبر 2023 محاولة تأسيسية لمنهج الوساطة ولصياغة المطالب الفلسطينية والسعي إلى وقف الحرب ومستقبل قطاع غزّة على أساس المسؤولية المتبادلة بين طرفي الحرب، فقد رأت المبادرة أهمية إبعاد الوحدات الإسرائيلية عن التجمّعات السكنية ووقف الهجمات الجوية وتوفير المساعدات الأساسية.
وبشكل عام، انشغلت السياسة المصرية بتحسين شروط الانتقال ما بين مراحل ما بعد وقف إطلاق النار، كان منها إلزام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بشروط التهدئة غير أنّ تعثّر الوساطة وانفلات حكومة الاحتلال وتوسّع هجومها على المدنيين عزّز الحاجة للانتقال من مرحلة الاصطفاف العربي ـ الإسلامي، للبحث عن دور حلفاء إسرائيل للمشاركة في ضمان مراحل التهدئة وبناء السلام. ولذلك، قرأت المبادرة الأميركية (خطة ترامب) في إطار ربط وقف الحرب بالسلام الإقليمي.
وعلى الرغم من الانسحاب الأميركي وضعف الجدوى السياسية، أبقت مصر على هيكل الوساطة قائمًا، ليشكل الركيزة الأساسية للوصول لإطار شرم الشيخ في 6 و13 أكتوبر 2025، لتُكسب صيغة شرم الشيخ الوساطة وضعًًا قانونيًا، تَعزّز بضم تركيا رسميًا بعد أن كانت ضمن الإطار السياسي الداعم لوقف الحرب.
وتمثلت السياسة الثانية في حشد قادة الدول المؤثّرة في السياسة العالمية، لدعم التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وذلك بالإضافة لبناء توافق دولي في التعامل على القضية الفلسطينية والحدّ من مخاطر امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. كانت الاستجابة لقمّة القاهرة مُخيّبة للآمال؛ فمن جهة، غَيّب تواضع مستوى التمثيل الأوروبي والأميركي التفويض اللازم للتفاهم على وقف الحرب. ومن جهة أخرى، يكشف مستوى التمثيل العربي والإسلامي عن اختلاف إدراك وضعية الحرب وتهديدها، حيث غلب تمثيل الدول بوزراء الخارجية.
وعلى خلاف قمّة القاهرة، حدث تغيّر واضحٌ في التمثيل الدولي في قمّة شرم الشيخ، لم يتوقّف عند الرئاسة المشتركة من مصر والولايات المتحدة، بل تعدّاه لمشاركة أكثر من قادة 20 دولة تقريبًا، لتبدو مؤتمرًا جامعًا للقوى الدولية الفاعلة في مجريات الشرق الأوسط، فقد جمعت ما بين ممثلي الكتلة الأوروبية والمجموعة الإسلامية، لتكون أكثر تفويضًا في اتخاذ قرارات لحل أو تسوية الصراعات.
ولذلك، رتّبت مصر قمّة شرم الشيخ لتكون مظلّة عالمية لتجميع مساري التحالف من أجل تنفيذ حل الدولتين ومبادرة الولايات المتحدة في مسار واحد مُلائم لتسوية الخلافات حول المقاومة وإقامة الدولة الفلسطينية، وهي صيغة أقرب لاستعارة سياق مفاوضات السلام المصرية ـ الإسرائيلية في نوفمبر 1977، ولكن تحت رعاية مشتركة من أربعة أطراف؛ مصر، تركيا وقطر والولايات المتحدة، لتكون إطارًا جديدًا لتسيير عملية إنهاء الحرب في غزّة والضفة الغربية، بما يضمن التعافي والإعمار والتنمية. على هذه الأرضية، تمثّل قمّة شرم الشيخ قيمة مضافة لقمّة القاهرة للسلام، حيث تمكّنت من تجاوز التناقضات المانعة من مشاركة الدول، كما وصلت لتفاهمات مع أوروبا والولايات المتحدة.
وكانت السياسة الثالثة ماثلة في فتح الآفاق لتسوية الصراع على أساس حلّ الدولتين، والاستقرار الإقليمي. وخلال الفترة ما بين انعقاد القمّتين، عملت مصر على تطوير أهدافها من التهدئة لربط إنهاء الحرب بتحقيق السلام في الشرق الأوسط. تطلّبت هذه السياسة الاستناد إلى كتلة دولية، وبالنظر لأداء قمّة القاهرة، لفت الانقسام الغربي الإسلامي الانتباه لأهمية تطوير صيغة عربية ـ إسلامية لمواجهة التحالف الأوروبي الأميركي. وقد ظهر أثر هذا التوجّه في صيغة مؤتمرات القمّة الإسلامية، لتشهد الفترة اللاحقة عملية واسعة لجامعة الدول العربية ومنظّمة التعاون الإسلامي، بدأت أعمالها في قمة الرياض، 11 نوفمبر 2023، وقمّة الثماني الإسلامية، القاهرة في ديسمبر 2023، ثم قمّة الرياض في نوفمبر 2024 للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، لترسي هذه الاجتماعات لمواقف مشتركة، كانت رافعةَ لوضع القضية الفلسطينية في وسط التفاعلات الدولية.
بشكل عام، يرجع تبني هذه السياسات لإزاحة التهديد الناجم عن اشتعال الحروب على الحدود الأربعة وتهدئة الاضطراب الأمني الإقليمي، ليس نتيجة أحداث 7 أكتوبر (2023) فقط، ولكن بسبب التفكّك المُزمن في ليبيا، واندلاع الحرب الأهلية في السودان في 15 إبريل من العام نفسه، ثم التداعيات في البحر الأحمر والاضطراب في سورية. ما دفع إلى تعدّد مصادر لتنشيط الديبلوماسية واتخاذ مسار عسكري دفاعي.
في مناخ انعقاد القمّتين
صاحبت انعقاد القمّتين سياقات مُغايرة، انعكست على أداء الدول تجاه وقف الحرب. في البداية، واجهت السياسة المصرية عبئًا مزدوجًا، فإنه بالإضافة إلى أجواء انعقاد الانتخابات الرئاسية، جاء انعقاد قمّة القاهرة في سياق الرفض المصري للمساومتين الأميركية والألمانية. منذ بدء الأزمة، أدركت مصر أنّ إخلاء قطاع غزّة هدف أساسي للحرب. ولذلك، اتخذت سياسة وقائية، قامت على رفض التهجير باعتباره تصفية للقضية الفلسطينية. ولأجل هذا، دخلت في مجادلة لنقل العبء على إسرائيل في حلّ مشكلاتها الأمنية، وليس على حساب مصر أو الأردن. كان اقتراح "صحراء النقب" صيغة للردّ على الوساطة الألمانية لإغلاق المساومات القائمة على القبول بالتهجير لسيناء حلًّا لتهديد المقاومة.
قامت المساومة على تقييم بعدم قدرة مصر على مقاومة الصدمة من الفجوة ما بين التلاحم الأميركي والألماني مع إسرائيل وتباطؤ الاستجابة الإقليمية للتهديد الجديد. وظلّت هذه المقاصة أساسية على مدى الحرب، حيث قام الموقف الغربي على أنّ خطأ المقاومة مُبرّر كاف لاتباع سلسلة إجراءات لتأمين إسرائيل، كان منها نزع سلاح حركة حماس وإخلاء قطاع غزّة من السكان. طرح المستشار الألماني السابق أولاف شولتز ووزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن نمط المقايضة في مقابل تحمّل نفقات عملية التهجير والتوطين في مصر.
ترتّب على هذه الخلافات حدوث انقسام داخل قمّة القاهرة، أسّس لتباعد بين مصر والولايات المتحدة، ومع عجز إسرائيل عن فرض التهجير، رغم إخلالها بالاتفاقات، أو إسقاط النظام الإيراني، انهار دور الحرب في تغيير المراكز التفاوضية. وبينما اتسعت حرية مصر في تطوير دورها السياسي، لم تستطع حكومة نتنياهو تطوير أهدافها من استمرار الإبادة، خصوصًا مع عجزها عن استرداد الأسرى والقتلى أو اقتحام مدينة غزّة.
وخلال الفترة ما بين القمّتين، نشطت السياسة المصرية في تمتين العمل الجماعي على مستوى الدول الإسلامية. كانت البداية في الدعوة لانعقاد قمة "الثماني الإسلامية في القاهرة، ديسمبر 2023، ثم القمّة العربية الطارئة في مارس 2024 وإقرار خطة الإعمار مارس 2025. وكانت ذروة التصعيد المصري في قمّة الدوحة، 15 سبتمبر 2025، عندما وصفت إسرائيل بالعدو تعبيرًا عن رفض الفلتان الإسرائيلي والتضامن مع قطر.
ومع تصاعد فاعلية التحالف الدولي في دعم الاعتراف بدولة فلسطين، زادت القابلية لوقف الحرب في المناقشات الدولية. وكما ساهمت مصر في تفعيل الوساطة وانتقالها إلى شرم الشيخ، تلاقت المبادرة الأميركية (خطة ترامب)، مع الرغبة في تثبيت الفلسطينيين على أرضهم والتطلّع إلى إنهاء الحرب، كما وهو ما يتسق مع محتوى خطاب ترامب في الكنيست بتقديم السلام بما هو مصلحة لإسرائيل، لتكون قمّة شرم الشيخ في بيئة توافق دولي على الحل السياسي.
في سياقات القمّتين
يعكس تباين مخرجات القمتين حالة من التطوّر في السياسة المصرية، فبينما انتهت قمّة القاهرة من دون بيان ختامي، انتهت قمّة شرم الشيخ إلى وثيقة دولية تنتهي أهدافها لوقف الحرب وتحقيق السلام الإقليمي. في قمّة القاهرة، كانت الكلمات تكرارًا لمواقف سابقة ولم تعكس حدوث أي مشاورات بين المشاركين، لتبدو القمّة ساحة جزرٍ منعزلة الرؤى والأهداف، وقد تسبّب الخلاف حول ثلاث نقاط: تصنيف المقاومة منظمات إرهابية، وحقّ إسرائيل في الدفاع الشرعي تحت مظلّة أولوية أمنها، وتهجير سكان غزّة إلى سيناء، بعدم صدور بيان ختامي، جرى تعويضه ببيان من الرئاسة المصرية 21 أكتوبر 2023، ليكون تعبيرًا عن اتساع مساحة الخلاف مع الدول الغربية وتفكّك المواقف العربية والإسلامية.
ورغم ضعف الأداء الجماعي، استقرّت المواقف الغربية على رفض المساومة على أولوية أمن إسرائيل في مقابل إزهاق الحقّ في مقاومة الاحتلال. وعلى خلاف الموقف الأوروبية، لم تتخذ الدول العربية موقفًا مشتركًا، وبدت كلمات الوفود خالية من مؤشّرات اتخاذ إجراءات مشتركة لتخفيف الأزمة في غزّة. ورغم تواضع مخرجات قمّة القاهرة، فإنه حسب بيان رئاسة الجمهورية، لم يكن أمام مصر سوى استمرار العمل مع الشركاء للحفاظ على الحقوق الفلسطينية وإحلال السلام وسدّ الطرق أمام كلّ ما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أيّ دولة بالمنطقة أو تهديد أمنها القومي.
وبعد عامين تقريبًا، صدر إعلان "شرم الشيخ للسلام" الخطوط العريضة للانتقال من الحرب للسلام، حيث يمكن قراءته إعلانَ مبادئ للسلام في الشرق الأوسط شاملًا ضمانات المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في غزّة، وبهذا المعنى، لا يقتصر تقييمه على التداعيات المُصاحبة لوقف أعمال الحرب في القطاع، بل يرتبط بتقييم سلوك الدول تجاه مجريات الوضع الإقليمي واستقرار المصالح العالمية.
يرجع الجدل حول الترتيبات الانتقالية والمآلات النهائية لعملية السلام لاختلاف الإرادة الدولية حول وضعية قطاع غزّة. فبينما تذهب الخطة الأميركية لفرض حالة نفوذ خارج الأمم المتحدة لا تضمن الوصول للدولة الفلسطينية لحساب الانشغال بدمج إسرائيل إقليميًا، قامت السياسة المصرية على استمرارية الطابع الفلسطيني للحل السياسي على أن يقتصر دور الضامنين على اتخاذ التدابير اللازمة لتثبيت الاتفاق. ولذلك تُولي مصر اهتمامًا بالمصالحة الوطنية ووحدة الفصائل لضمان سلامة التمثيل أمام العالم، وخصوصًا فيما يتعلّق بوجود حركات المقاومة في ترتيبات البيت الفلسطيني.
على أيّة حال، تعكس هذه النتائج حالة تطورية، فهي لم تقتصر على تهدئة قتال بل تطلّعت لإنهاء الحرب والتحوّط ضدّ اتساعها إقليميًا. فعلى خلاف قمّة القاهرة، تقاطعت سياسة مصر مع الخطة الأميركية للسلام، لكنها رأت أهمية إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب والتطرّف، وهي صيغة مختلفة عن مشروع التطبيع (الإبراهيمي) من وجهة مراعاة تطلّعات الأطراف المختلفة، وليس تمكين إسرائيل وحدها. وهنا، يسعى المنظور المصري إلى أن يكون السلام على أرضية مصالح مشتركة تحقّق السلام فعلًا، ولا تقتصر على ضمان الحقوق الفلسطينية فقط، وإنما تقوم على الشراكة الإقليمية في الأمن والاقتصاد.
بشكل عام، لا يعني حدوث تطوّر نوعي في الأداء السياسي ما بين القّمتين تلاشي إمكانية الإخلال بالترتيبات السياسة والأمنية، حيث توفّر البيئة الهشّة قيودًا على التسويات السلمية. وهنا، يضاعف نمط الحرب غير المتناسقة من فرصة الإفلات من التزامات المراحل التالية للاتفاق؛ فمن جهة تُحاكي حكومة الاحتلال تصرّفات المليشيا المسلّحة عندما تتنكّر لمسؤوليتها عن حماية المدنيين، ومن جهة أخرى، أضعفت حرب السنتين التماسك الداخلي في حركات المقاومة.
وعلى الرغم من وجود مُحفّزات الانفلات، تمكّنت السياسة المصرية من تثبيت رفض للتهجير وزيادة الاندماج مع الفاعلين الدوليين والإقليميين، لتكون فاعلية الضمانات مُهمة مشتركة، يقوم أحد جوانبها على التنسيق ما بين مصر وقطر وتركيا لإبقاء الإطار الإسلامي رافعة للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بجانب الاستفادة من الاستجابة الأميركية السريعة لتطويق أحداث رفح الأخيرة في التقدّم نحو وقف إطلاق النار وضبط سلوك المجموعات الميدانية وتثبيت الاتفاق ضدّ الخروقات الأمنية.