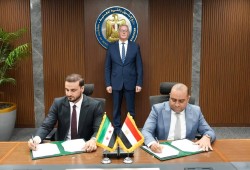خلال مرحلة ما بعد الثورات العربية، وبالذات منذ 2013، مثّل ملف الإخوان نقطة التقاء مركزية بين الرياض وأبوظبي، حيث دعمت العاصمتان انقلاب الثالث من يوليو في مصر، وشاركتا في حملة إقليمية واسعة لتجريم الجماعة وضرب امتدادها السياسي والشعبي. لم يكن ثمة خلاف جوهري بين البلدين وقتها على توصيف "الخطر الإخواني"، بل كان التحالف الأمني – السياسي قائمًا على هذا الأساس.
لكن الخطاب الذي يرصده نواف القديمي يكشف تحوّلًا لافتًا؛ فمصطلح "الإخوان" – وفق رأيه – لم يعد يعبّر عن جماعة أو فكر، بل صار يُستخدم لوصم أي طرف يقف في مواجهة سياسات الإمارات، حتى لو كان هندوسيًا أو لا دينيًا. هذا الاستخدام المفرط جعل المصطلح يفقد دقته التحليلية، ويتحول إلى سلاح لغوي يتم إطلاقه على الخصوم بلا ضوابط، حتى بات – من حيث لا يقصد بعض مطلقيه – بمثابة "ثناء غير مقصود" على الجماعة من حيث حجم الهوس بتوجيه التهم إليها في كل اتجاه.
شماعة جاهزة لتأطير كل خلاف
توسّع شخصيات إماراتية نافذة – مثل عبد الخالق عبد الله وضاحي خلفان وأنور قرقاش – ومعها جيش من الحسابات المنظمة، في استخدام مصطلح "الإخوان" لتأطير أي توتر سياسي في المنطقة، يعكس انتقال هذا الملف من كونه خلافًا أيديولوجيًا إلى أداة صراع وتعبئة. فبدل الحديث عن جذور الخلاف الميدانية أو الاستراتيجية – كما في اليمن أو ملفات الطاقة – يجري استحضار "الإخوان" كإطار تفسيري جاهز يشحن الجمهور عاطفيًا ويوجه بوصلته بعيدًا عن الأسباب الحقيقية.
رسالة د. محمود حسين، القائم بأعمال المرشد العام، تلتقط هذه النقطة بوضوح؛ إذ يرى أن وصم الجماعة – بوصفها أكبر التنظيمات الإسلامية ذات الطابع الإصلاحي والتربوي – بالإرهاب ليس إلا محاولة من "صنّاع الحروب" لمنح خطاب العنف قبلة الحياة، وصرف الأمة عن قضاياها المركزية وعلى رأسها التحرر الوطني وقضية فلسطين، وتمكين المستبدين والمفسدين. بهذا المعنى، تتحول "شماعة الإخوان" إلى جزء من هندسة المشهد الإقليمي لصالح قوى الاستبداد والتطبيع، أكثر من كونها أداة لمواجهة تطرف حقيقي.
بين الرياض وأبوظبي: خلافات ميدانية تُلبَّس لبوسًا أيديولوجيًا
الخلاف السعودي الإماراتي الراهن يتصل – وفق ما يتداوله المراقبون – بملفات ميدانية واقتصادية واضحة: اليمن (دعم أبوظبي للمجلس الانتقالي الجنوبي مقابل توجهات سعودية مغايرة داخل الشرعية)، التنافس على النفوذ الإقليمي، وتباينات داخل "أوبك بلس" وسياسات الاقتصاد والطاقة. مع ذلك، توظّف أطراف مقربة من الإمارات خطاب "الإخوان" لإعادة صياغة الخلاف بوصفه صراعًا بين "معسكر حازم ضد الإسلام السياسي" وآخر "متساهل" أو "متخادم" معه.
في المقابل، يظهر خطاب سعودي مضاد؛ تركي القحطاني يتهم الإمارات بتبنّي "مكارثية سياسية" عبر اتهام الرياض بأنها "إخوان ودواعش" وبأنها تنشر مراكز دعوة في جنوب اليمن لخدمة مشروع مذهبي، معتبرًا أن هذا التشويه غطاء لمشاريع أخطر تضرب اليمن والمنطقة. ويذهب سامح عسكر في الاتجاه نفسه، معتبرًا أن الإعلام الإماراتي بات يصف أي تحرك سعودي بأنه "إخوان وقاعدة"، بينما تدعم أبوظبي تكوينات مشابهة في ساحات أخرى، ما يجعل تهمة "الإخوان" مجرد "آخر كارت" بيد محور مضطرب الخطاب والممارسة.
سرد خالد الأنسي لتسلسل التصعيد يكشف أن لغة التخوين والمهانة المتبادلة تجاوزت حدود النقد السياسي إلى مستوى الشتائم الشخصية، واستدعاء ملفات مثل خاشقجي، والسخرية من الدعوات لمقاطعة الإمارات، واتهام السعودية بالجحود لولا "حماية عيال زايد". في هذا المناخ، يصبح استدعاء "الإخوان" جزءًا من حزمة كاملة من أدوات التشويه، لا علاقة لها بقراءة جادة لواقع الحركات الإسلامية أو لموقعها في المشهد.
من الإخوان إلى السلفيين: توسّع دائرة الشيطنة
استخدام أبوظبي لملف "الإخوان" لا يتوقف عند الخلاف مع الرياض؛ بل يتمدد – كما يلاحظ داهم القحطاني – إلى شيطنة التيار السلفي ذاته، رغم أنه تيار أصيل في البنية الدينية والاجتماعية الخليجية. القحطاني يلفت إلى أن الإخوان والسلفيين – رغم أخطائهما – يمثلان جزءًا من نسيج المنطقة منذ عقود، وأن البدائل المطروحة أخطر بكثير، لأنها تسعى لخلع المجتمعات من جذورها الإسلامية واستبدالها بمشاريع "مُطبِّعة" تجعل اليهودية والمسيحية أقرب للوجدان الخليجي من هذين التيارين المنتميين لأهل السنة والجماعة.
في هذا السياق الأوسع، يبدو أن شيطنة الإخوان ثم السلفيين ليست سوى خطوة في مسار إعادة تشكيل الهوية العامة للمنطقة بما يتوافق مع أجندات سياسية واقتصادية وأمنية عابرة للحدود، بينما تُستخدم تهمة "الإخوان" كواجهة سهلة للهجوم على كل من يعارض هذه الأجندات، سواء في ليبيا أو تونس أو اليمن أو غيرها، مع استدعاء أسماء مثل علي الصلابي لتثبيت رواية أن أي تقارب سعودي مع قوى معينة يعني دعم "مليشيات إخوانية".
واخيرا فان تحوّل "الإخوان" من توصيف فكري وتنظيمي إلى تهمة سياسية عابرة للمعنى، يكشف جانبًا معتمًا من طبيعة الصراعات في المنطقة: أن الأنظمة وأبواقها لا تبحث عن الحقيقة بل عن "أداة" تُشوه بها خصوم اليوم، حتى لو كانوا حلفاء الأمس. وفي خضم هذا الاستخدام الانتهازي، تُختزل قضايا مصيرية – كاليمن وفلسطين وإصلاح الداخل – في معارك لفظية حول "الإخوان" و"الدواعش"، بينما تتقدم مشاريع التطبيع والاستبداد خطوة بعد أخرى تحت دخان هذه المعارك المصطنعة.
النتيجة أن الخطاب الذي يفترض أنه يحارب "التطرف" ينتهي عمليًا إلى خدمة أكثر التيارات تزمتًا واستبدادًا داخل الدولة العميقة، وإلى تهميش الحركات الإصلاحية الوسيطة التي كان يمكن أن تشكل جسورًا بين الهوية الإسلامية ومتطلبات الدولة الحديثة. وفي النهاية، يدفع ثمن هذا العبث الشعوب، التي تُساق من معسكر تشويه إلى آخر، دون أن تُمنح حقًا حقيقيًا في تقرير مصيرها أو اختيار نماذج حكم تعبّر عن إرادتها بعيدًا عن "فزّاعة الإخوان" التي يُعاد تدويرها بحسب مقتضيات كل موجة صراع جديدة