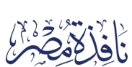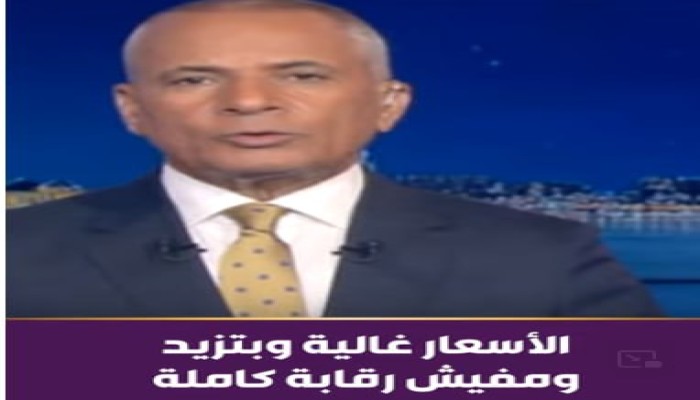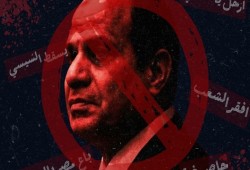في منعطف يكشف الكثير عن ديناميكيات الإعلام والسلطة والرأي العام في مصر، تحول خطاب الإعلامي أحمد موسى، الذي طالما كان الحصن الإعلامي المنيع للدفاع عن سياسات الدولة الاقتصادية، إلى منصة تبث شكوى المواطن من غلاء الأسعار.
تصريحاته الأخيرة، التي وصفت بألم حقيقي معاناة الأسر المصرية بقوله إن "وجبة الفول والطعمية بـ 70 جنيه" وإن "المرتبات مش مكفية وكل البيوت تعبت"، ليست مجرد تبدل في الآراء، بل هي انعكاس لحقيقة دامغة: أن موجة "الاختناق" الاقتصادي والاجتماعي في الشارع المصري وصلت إلى مستوى لم يعد من الممكن تجاهله أو تبريره بالأساليب القديمة.
من التبرير إلى التنفيس: عندما يصبح الواقع أقوى من السردية
في السابق، كان خطاب أحمد موسى يرتكز على تبرير الإجراءات الاقتصادية الصعبة، وربطها بالسياق العالمي أو بضرورات الإصلاح طويل الأمد. كان غالباً ما يقارن الأوضاع في مصر بدول أخرى، أو يذكر المواطنين بنعمة الأمن والاستقرار التي تستحق التضحية.
لكن هذا النهج لم يعد فعالاً أمام ضغط الواقع اليومي الذي يعيشه المواطن. لقد أصبحت حالة السخط أكبر من أن يتم احتواؤها بالتبريرات، وهنا يأتي "تلون" الخطاب كضرورة تكتيكية وليس كقناعة جديدة.
يعترف موسى اليوم صراحةً بأن "الأسعار غالية وبتزيد ومفيش رقابة كاملة" وأن "المواطن بيدفع تمن مرحلة صعبة".
هذا الاعتراف ليس نقداً حقيقياً بقدر ما هو محاولة ذكية لإعادة التموضع. فهو ينتقل من دور المدافع عن القرار إلى دور المشارك في الشعور بالألم، وهو ما يخدم عدة أهداف متزامنة:
- امتصاص الغضب وتوجيهه: يعمل هذا الخطاب كـ"صمام أمان" يمتص شحنات الغضب المتراكمة في الشارع. عندما يجد المواطن أن معاناته يتم التعبير عنها على منصة إعلامية كبرى، فإنه يشعر بأن صوته مسموع، مما قد يقلل من حالة الاحتقان ويمنع تحولها إلى أفعال احتجاجية غير محسوبة.
- خلق عدو مشترك: يتم توجيه اللوم ببراعة نحو أهداف محددة: جشع التجار، غياب الرقابة الكاملة، أو الضغوط الخارجية من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي. هذا يخلق "أعداء" مشتركين يمكن للجمهور توجيه غضبه إليهم، مع إبقاء صورة صانع القرار الأساسي بمنأى عن النقد المباشر.
- الحفاظ على المصداقية: استمرار الإعلامي في إنكار حقيقة يعيشها ملايين المصريين يومياً هو انتحار مهني. هذا "التلون" هو محاولة للحفاظ على ما تبقى من مصداقية لدى الجمهور، وإعادة بناء جسور الثقة مع شريحة واسعة شعرت بأن الإعلام الرسمي منفصل تماماً عن واقعها.
أبعاد هذا التحول: ليس تغييراً بل تكيّفاً
سر هذا التحول لا يكمن في تغيير القناعات، بل في التكيف مع متغيرات المشهد. يمكن قراءة أبعاده كالتالي:
- إدراك خطورة التجاهل: يبدو أن هناك إدراكاً في دوائر ما بأن تجاهل حالة "الاختناق" الشعبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. لذلك، أصبح السماح بمساحة من "النقد الموجه" ضرورة للحفاظ على الاستقرار. أحمد موسى هنا يقوم بدور وظيفي، فهو يعبر عن هذا الغضب لكن ضمن حدود مرسومة بعناية.
- تأطير المعاناة كجزء من السردية الوطنية: لا يقدم موسى الشكوى بمعزل عن سياقها. فهو يربطها دائماً بأن "القيادة تشعر بكم" وأن هذه المعاناة هي "ثمن" ضروري للحفاظ على الدولة ومنجزاتها في الأمن والبنية التحتية. بهذا، تتحول المعاناة من دليل على فشل السياسات إلى "تضحية وطنية" مؤقتة في سبيل هدف أسمى.
- التمهيد للمستقبل: يصبح هذا الخطاب النقدي أداة لتمرير رسائل الدولة بشكل أكثر سلاسة. عندما يعترف موسى بصعوبة الوضع، ثم يبشر بـ"انفراجة قادمة"، يكون للرسالة تأثير أكبر. إنه يمهد الطريق نفسياً للجمهور لتقبل أن "المرحلة الصعبة" الحالية هي فترة انتقالية ستعقبها أيام أفضل.
في التحليل النهائي، فإن "تلون" خطاب أحمد موسى هو استجابة حتمية لواقع أصبح من المستحيل إنكاره. إنه ليس تمرداً أو تغييراً جذرياً، بل هو تطور في الأداء الإعلامي ليصبح أكثر ذكاءً وقدرة على احتواء المشاعر العامة. انتقل دوره من "المبرر" الصريح إلى "المعبر" عن الألم الشعبي، ولكن بشكل وظيفي يخدم في نهاية المطاف استقرار السردية الرسمية في وجه موجة "اختناق" شعبي غير مسبوقة.