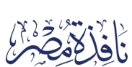د. محمد أبو رمان
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية والمستشار الأكاديمي في معهد السياسة والمجتمع
يسارع مراقبون وسياسيون كثيرون قفزًا إلى خلاصاتٍ تتعلّق بمستقبل الحركات الإسلامية هنا أو هناك، ومن ذلك حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تمرّ اليوم بأحد أقصى الاختبارات وأصعبها، ليس على صعيد التهديد العسكري والأمني الوجودي فقط، بل حتى على صعيد التوافق الداخلي في التعامل مع هذا التهديد، الذي لا يصيب الحركة وحدها، بل المشروع السياسي الفلسطيني بأسره. إذ تواجه الحركة في "اليوم التالي" للحرب على غزّة أسئلةً وجوديةً ومصيريةً، لا تملك الإجابة عن الحزمة الأولى، لأنّها مرتهنة بأجندات دولية وإقليمية نحو دور الحركة في المرحلة المقبلة في قطاع غزّة، وإدماجها سياسيًا أو إقصائها، ومصير قادتها في الداخل والخارج، وسؤال السلاح والجناح المسلّح. أمّا الحزمة الثانية فمرتبطة بالإجابات التي ستقدّمها الحركة في المرحلة المقبلة، التي قد تنعكس على الحزمة الأولى من الأسئلة بصورة أو بأخرى.
القفز إذًا لرسم سيناريوهات مستقبل الحركة (بصورة عامة) تعميم واستنتاج مبكّران (مثل النظريات التي قالت بنهاية الإسلام السياسي في مرحلة التسعينيّات أو أفوله)، لماذا؟... لأنّ مصير الحركة لا ينفصل عن مصفوفاتٍ من المتغيّرات الهائلة، بعضها متعلّق بالأوضاع الإقليمية، وهي إلى اللحظة غير مستقرّة وتواجه حالةً من انعدام اليقين بين أجندات متضاربة إسرائيلية وأميركية وإيرانية وعربية، وبعضها متعلّق بالوضع الفلسطيني في الضفة الغربية وغزّة، وبعضها متعلّق بالحركة نفسها والأسئلة الداخلية، والنخبة التي ستتولّى الأمور بعد استشهاد كثيرين من قياداتها المؤثّرة في الداخل والخارج، ومَن النخبة التي ستمسك بزمام الأمور وما خياراتها الفكرية والاستراتيجية، ومدى تماسك الحركة وصلابتها في التعامل مع التحدّيات الجديدة.
بالرغم من الكمّ الكبير المؤثّر من المتغيّرات التي يمكن أن تتفاعل في رسم مصير الحركة ومستقبلها، هنالك متغيّراتٌ تأخذ درجةً أكبرَ من الأهمية في التحليلَين، السياسي والاستراتيجي، في هذا المجال. يتمثّل الأول في البعد الجيوسياسي بما يتضمّنه من مصالحَ وأجنداتٍ داخلية وخارجية، والثاني في النخبة السياسية في الحركة وخياراتها الاستراتيجية، ويتعلّق الثالث بالعلاقة بين الحركة والمجتمعات المحلّية أو القواعد الاجتماعية في غزّة والضفة والشتات. على الصعيد الجيوسياسي، تعاني الحركة من غياب السند الاستراتيجي إقليميًا ودوليًا، فقد كان محور الممانعة متكفّلًا خلال الأعوام الماضية، بدرجة كبيرة، بالدعمين، المالي والعسكري، وتشكيل ميزان قوى إقليمي، نجمت عنه "عقيدة وحدة الساحات" (حتى لو لم تكن فعّالةً، لكنّها مثّلت محورًا إقليميًا)، بينما لا يوجد بديل إقليمي في اللحظة الراهنة يمكن أن يحمل الحركة سياسيًا وإقليميًا، ولا يوجد وضوح في التصوّرات الدولية والإقليمية لمستقبلها ودورها السياسي. وحتى اللحظة، تنظر الأجندة الأميركية والأوروبية إلى الحركة باعتبارها غير مشروعة، وتوصف بالإرهابية من هذه الدول. وإقليميًا، أغلب دول ما يسمّى "الاعتدال العربي"، حتى لو تعاملت مع الحركة مؤقتًا، تعاديها سياسيًا واستراتيجيًا. ولا يُتصوَّر أن يكون الدور التركي خلال المرحلة المقبلة بديلًا من الإيراني، إذ هنالك اختلافات واسعة، فضلًا عن أنّ السياسة التركية تتسم بالبراغماتية الشديدة، وتركّز خلال الأعوام الماضية على التصالح مع الدول العربية، وعلى توثيق التحالف مع إدارة ترامب، وعلى المصالح الاستراتيجية في سورية.
هذه البيئة الاستراتيجية والسياسية المحيطة بالحركة يمكن أن تتغيّر بسبب حالة السيولة الإقليمية، ويتعلّق الأمر بالأجندة الصهيونية لبنيامين نتيناهو وحكومته المتطرّفة في المرحلة المقبلة؛ هل سيكون هنالك مشروع "سلام إقليمي" كما يدعو ترامب، أم ستؤدّي سياسات نتنياهو إلى توتير المنطقة وتعزيز حالة عدم الاستقرار. والعلاقة مع إيران متغيّر مهم في هذا السياق، كما أنّ السياسات الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية والقدس تمثّل متغيرًا آخر لا يقلّ أهميةً في تأطير المشهد المقبل، بخاصة أنّ السياسات الإسرائيلية، منذ نتنياهو، ترفض التعامل مع حركتي فتح وحماس على السواء.
إذا وقفنا عند حدود غياب الحليف الإقليمي الاستراتيجي، فإنّ السؤال هو ما إذا كانت هنالك تصوّرات ونظريات لدى طرف من القيادة في الحركة لإعادة فتح مجالٍ من العلاقات الواقعية مع المحيط الإقليمي العربي، ما يعني بالضرورة تحوّلاتٍ وتعديلًا في خطاب الحركة الفكري والسياسي، وهو خيار يبدو صعبًا لكنّه ممكن، بخاصة إذا أخذنا بالاعتبار مسألتَين رئيستَين: الأولى، أنّ الحركة سبق أن قامت باستدارات في تحالفاتها الإقليمية، في مرحلة التحالف والتعاون مع حلف الممانعة، ثمّ الانفكاك عنه مع الثورة السورية، والتقارب مع تركيا في "الربيع العربي"، ثمّ في مرحلة لاحقة، ومع سيطرة حركة حماس الداخل - غزّة على مقاليد الأمور في الحركة، منذ العام 2020، عاد التحالف قويًا مع إيران، بينما أُضعف خالد مشعل والمكتب السياسي في الخارج بصورة كبيرة وواضحة.
يقود ما سبق إلى المتغيّر الثاني المهم، وهو موازين القوى داخل الحركة نفسها، ومن هي النخبة التي يُتوقَّع أن تقود الحركة في المرحلة المقبلة، إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات داخل الحركة خلال العام الماضي، لكنّ الظروف العسكرية والأمنية، واستشهاد القيادات، حالت دون ذلك، ولا تزال هنالك حالة من الفراغ القيادي، وتشير مصادر قريبة من أوساط الحركة إلى وجود مراجعات ونقاشات داخلية حاليًا للإجابة عن عدة أسئلة وتساؤلات تتعلّق بتعريف الحركة، وما إذا كانت حركةً جهاديةً لها جناح سياسي، أم حركةً سياسيةً ولها جناح عسكري، وفي ترسيم (وتأطير) العلاقة بين الجناحين العسكري والسياسي. فكان واضحًا خلال الأعوام الماضية أنّ الجناح العسكري كان له دور رئيس في التأثير في القرار السياسي للحركة، وحتى في تحالفاتها الإقليمية والخارجية.
لطالما كانت جدلية الداخل والخارج حاضرةً في موازين القيادة في الحركة، وإن لم تكن واضحةً كما هي الحال اليوم، فالمكتب السياسي بقيادة خالد مشعل وموسى أبو مرزوق وغيرهما توسّع، وأخذ دورًا قياديًا كبيرًا في التسعينيّات، بخاصة مع وجود نسبة كبيرة من القيادات في غزّة والضفة الغربية في السجون، وبقي الجناح السياسي ممسكًا بالقوة، ومستفيدًا من قدرته على نسج تحالفات سياسية واقتصادية ومالية إقليمية في الخارج، وهي المعادلة التي تغيّرت كثيرًا منذ أعوام، بخاصة مع الاختلاف بين الجناحين في التعامل مع الثورة السورية، وانتهى الأمر لاحقًا إلى صعود حركة حماس الداخل - غزّة، وتراجع كبير في حركة حماس الخارج، وضعف شديد في جناحها في الضفة الغربية.
لا توجد مؤشّرات واضحة على تحوّلات القيادة في المرحلة المقبلة، وإن كانت الظروف التي من المتوقّع أن تمرّ بها غزّة ستعزّز قوة "حماس الخارج"، بخاصة التيار البراغماتي بقيادة خالد مشعل، الذي كان خارج إطار التخطيط الاستراتيجي لـ"طوفان الأقصى" بالكلّية، وهو التيار المعروف بمرونته الشديدة ومحاولته المضي بالحركة نحو قدر أكبر من التسييس والواقعية والتحالفات الإقليمية، الأمر الذي انعكس على الوثيقة السياسية المهمة التي أصدرتها الحركة في العام 2017 وحملت تغييرات ملحوظة في الخطاب الأيديولوجي والسياسي للحركة، مع الابتعاد عن اللغة القطعية الدينية والعقائدية التي هيمنت على وثيقة الحركة التأسيسية في نهاية الثمانينيّات.
ما هي قوة التيار البراغماتي في الخارج؟ وهل سيعود مشعل إلى قيادة الحركة بعدما جرّب التنظيم الداخلي المقرّب من كتائب عزّ الدين القسام القيادة، وقاد عملية طوفان الأقصى وما تمخّض عنها من نتائج كبيرة على الصعيدين السياسي والاستراتيجي؟ بخاصة أن "حماس – غزّة" ستكون في مرحلة صعبة وغير واضحة الملامح، ما قد يستدعي قيادةً خارج إطار الضغوط الشديدة التي تواجهها في الداخل. لا يزال مشعل أحد أبرز الأسماء في الخارج، ومعه موسى أبو مرزوق، بينما يبدو أسامة حمدان، الذي كان تقليديًا أقرب إلى التعاون مع محور الممانعة (انضمّ إليه لاحقًا غازي الحمد)، بعيدَين عن هذه الحسابات. وفي الداخل، هنالك قيادات ميدانية لا تزال موجودةً، مثل توفيق أبو نعيم ومحمود الزهّار وعزّ الدين حدّاد، وربّما قيادات ميدانية عديدة أخرى.
لا يقلّ الجانب الثالث أهميةً عن كل ما سبق، ويتمثّل في سؤال العلاقة بين الحركة والقاعدة الاجتماعية، والمقصود هنا الفلسطينية بدرجة رئيسة، سواء كنّا نتحدّث عن قطاع غزّة أو الضفة الغربية أو فلسطينيي الشتات، ويتفاعل هذا المتغيّر بدرجة كبيرة مع متغيّرَين آخرَين؛ بمعنى لو افترضنا حلقةً أو مسارًا جديدًا لحركة حماس عبر قيادات الخارج (الجناح البراغماتي)، وتمكّنت الحركة من اختراق الأجندات الدولية أو الإقليمية بعدم وجود "فيتو" لتمثيلها السياسي في المشهد الفلسطيني، وتمكّنت من إعادة تركيب بعض التحالفات الإقليمية في مواجهة السياسات الإسرائيلية الجديدة، فهذا قد يمكّن الحركة من إعادة تجديد (وتحفيز) قواعدها الاجتماعية في المناطق الأخرى، ليس في غزّة وحسب، بل في مناطق أخرى، وربّما أيضًا بعض الأصوات في غزّة المؤيّدة للرؤية التي يتبناها جناح "حماس – الخارج"، كما هي حال أحمد يوسف، وهو أحد أبرز المفكّرين في الحركة، ولا يزال في قطاع غزّة، لكنّه مهمّش لاختلافه السابق مع أراء يحيى السنوار والمجموعة التي أمسكت بالقيادة منذ 2020، وكانت له (يوسف) أراء نقدية شديدة لسلوك الحركة وسياساتها في غزّة، وفي التعامل مع الشروط الإقليمية والفلسطينية الداخلية.
قد يرى بعضهم أن أيَّ تغيير أو تحوّلات في مواقف الحركة بمثابة تراجع أو تخلّ عن الهُويَّة الأيديولوجية؛ وهو أمر بنظرهم غير وارد بعد تلك التضحيات الكبيرة، لكن الحركة، في الواقع وفي أحيانٍ كثيرة، استدارت وأجرت تحوّلات في المواقف والتحالفات السياسية، والأكثر أهمية التحولات في خطابها السياسي والأيديولوجي نفسه، وتكفي مقارنةٌ بسيطةٌ بين الوثيقة الأساسية وبين الوثيقة السياسية 2017، ولا مجال اليوم أمام الحركة إلاّ التفكير في التعامل مع المتغيّرات البنيوية في البيئة الدولية والإقليمية والداخلية الفلسطينية (في الضفة وغزّة)، وهو أمر يتطلّب قدرًا كبيرًا من المرونة والذكاء والقراءة الدقيقة لموازين القوى ومواقف الدول والأطراف المختلفة.