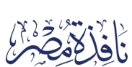خلص المجلس الأطلسي في ورقة بحثية إلى أن "عدم اليقين في السياسة الاقتصادية يُعتبر بمثابة مثبط للشركات عن التوظيف والاستثمار والوصول إلى الأسواق".
وطرحت رشا حلوة الباجثة في المجلس إنه "..من أجل معالجة التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد المصري، من الضروري تقييم ومعالجة المتطلبات الأساسية للاقتصاد السياسي، وليس التركيز فقط على أساسيات الاقتصاد الكلي".
وحذرت من أنه "بدون تعزيز أيديولوجية أكثر قوة مؤيدة للسوق، سواء داخل الحكومة أو بين عامة الناس، فستظل الإصلاحات الاقتصادية في مصر محاصرة في إطار حلقة من الركود لسنوات قادمة".
المؤشرات متواضعة
ويعاني الاقتصاد بحسب الورقة من تحديات مستمرة منذ ما يقرب من خمسة وسبعين عامًا. فلا تزال معدلات الفقر المرتفعة تؤرق الأمة، حيث تشير إحصاءات البنك الدولي إلى ارتفاع معدل الفقر، مع زيادة نسبة السكان تحت خط الفقر من 25.2% في عام 2010 إلى 32.5% في 2017-2018.
وأضافت أن عائدات السياحة في مصر متواضعة، حيث بلغ متوسطها حوالي 8-9 مليارات دولار سنويًا بين عامي 2014 و2022، على الرغم من إمكانات البلاد كوجهة سياحية رئيسة. وبالمقارنة، فقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار دخلاً سياحيًا أعلى، بمتوسط حوالي 30 مليار دولار سنويًا خلال نفس الفترة، بل ومن المتوقع أن تصل إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2028.
وأردفت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر متواضعة نسبيًا، حيث بلغت 11 مليار دولار في عام 2020. وهذا الرقم هو رقم ضئيل مقارنةً بدول أخرى متوسطة الدخل اجتذبت تدفقات استثمار أجنبي مباشر أعلى بكثير لنفس العام، مثل الهند (50 مليار دولار)، والبرازيل (70 مليار دولار)، وجنوب إفريقيا (90 مليار دولار). كما تعاني مصر من عجز تجاري مزمن، حيث سجّل 37 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، بانخفاض من 48 مليار دولار في عام 2022.
كيف تراكمت الديون؟
ولفتت الورقة التي نشرها المجلس الأطلسي إلى أن مصر عانت من عجز مالي بلغ في المتوسط 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي. ونتيجة لهذا، تراكمت لدى الحكومة ديون عامة ضخمة، حيث ارتفعت أرصدة الديون الخارجية، بما في ذلك ائتمان صندوق النقد الدولي، من متوسط 40 مليار دولار بعد الربيع العربي إلى 130 مليار دولار في عام 2020، بما في ذلك ما يقرب من 70% من الديون الطويلة الأجل، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد.
تفاقم الهشاشة
ووضعت الباحثة ضمن أول أسباب تفاقم هشاشة الاقتصاد المصري هو اعتماده على مصادر الإيرادات المتقلبة، بما في ذلك السياحة وقناة السويس والتحويلات الأجنبية.
وإن كانت وضعت أيضًا جائحة كورونا، وحرب أوكرانيا، وحرب غزة، والهجمات الأخيرة في البحر الأحمر – ضغوطًا اقتصادية إضافية على مصر.
إلا أنها استدركت إلى الخلاصة قالت إن الحساب الجاري، الذي أغلق بفائض متوسط بلغ 2 مليار دولار بين عامي 2002 و2007، إلى عجز كبير قدره 16 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022، ومن المتوقع أن يستقر عند 9 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2024.
تعويم متجدد
ورأت الباحثة أن ما شهده الجنيه المصري من خفض كبير في قيمته، أدى إلى أن خسر أكثر من 70% من قيمته منذ أوائل عام 2022، مما يجعله سادس أسوأ عملة أداءً على مستوى العالم منذ بداية هذا العام.
واعتبرت أن التأخير في تعديل سياسة الصرف الأجنبي أدى إلى ظهور سوق موازية، حيث كان الجنيه المصري قد انخفض إلى 68-70 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي، مقارنة بسعر ثابت يتراوح بين 30-31 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي في القطاع المصرفي الرسمي، حيث يكون المعروض من العملات الأجنبية ضئيلاً. كما تضاءلت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، حيث انخفضت من 44.6 مليار دولار في عام 2019 إلى 32 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022.
أسباب متجذرة
وأشارت الباحثة إلى تجذر الأزمة لـ75 عامًا وأن مفهوم “الأيديولوجية” أو “تأثير الأفكار” مبدًأ أساسيًا في الاقتصاد السياسي، ويقدم رؤى حول سبب تقدم بعض الدول بسرعة أكبر من غيرها، وعلى العكس من ذلك، سبب تأخر بعضها.
وقالت إن الأيديولوجية الاقتصادية المصرية دأبت منذ فترة طويلة على الالتزام بنهج الانغلاق على الذات واستبدال الواردات في ظل نظام جمال عبد الناصر (1950-1970)، وهو الاتجاه الشائع بين الاقتصادات النامية خلال حقبة إنهاء الاستعمار. ومن بين السمات الرئيسة لنظام عبد الناصر كان تأميم الأصول الخاصة، وإدارة المؤسسات الحكومية، واستبدال الواردات، وفرض القيود على الصادرات.
وفي وقت لاحق، سعى نظام أنور السادات (1970-1981) إلى عكس هذا الاتجاه من خلال تقديم تشريع استثماري جديد مؤيد للسوق وهو ما عُرف باسم سياسة “الانفتاح“. ومع ذلك، قوبلت أيديولوجيته بالرفض على نطاق واسع، كما يتضح من أعمال الشغب التي أعقبت قرارات رفع أسعار الخبز عام 1977. وفي عام 1981، وصل حسني مبارك إلى السلطة في أعقاب أعمال الشغب تلك، مما منعه من الشروع في إصلاحات جوهرية مماثلة. وبدلاً من ذلك، استخدمت حكومته نهجًا مختلطًا، فنفذت سياسات جزئية تدريجية مؤيدة للسوق بينما اعتمدت على بقايا قوية من عصر عبد الناصر. ويستمر هذا النمط حتى يومنا هذا. وقد تجلت هذه الإيديولوجية المختلطة، على سبيل المثال، في التقدم البطيء لبرنامج إدارة الأصول العامة (الخصخصة)، والحجم الكبير نسبيًا للقطاع العام في اقتصاد البلاد.
ومع ذلك، لكي تتبنى الأمة موقفًا مؤيدًا للسوق بشكل كامل، يجب أن تمتلك التزامًا أيديولوجيًا قويًا بالسياسات المؤيدة للسوق وحوافز سياسية واضحة لتعزيز هذه الإيديولوجية. وعلى سبيل المثال، فقد كان تبني برنامج التصنيع القائم على التصدير في كوريا الجنوبية (1962-1980) مسترشدًا برؤية طويلة الأجل للانضمام إلى صفوف الدول الأكثر تصنيعًا، وهو ما بلغ ذروته في انضمام البلاد بنجاح إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1996. وعلى نحو مماثل، فقد كانت تطلعات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هي الدافع وراء إصلاحها الاقتصادي المؤيد للسوق والتقدم الاقتصادي الشامل في الثمانينيات والتسعينيات. وفي الوقت نفسه، كانت الإصلاحات الاقتصادية في جنوب إفريقيا ما بعد نظام الفصل العنصري مدفوعة في المقام الأول بالتزام قوي بالقدرة التنافسية للأعمال والمساواة الاقتصادية.
وأضافت أنه بالمقارنة، لم تتبن مصر مطلقًا أيديولوجية طويلة الأجل موجهة نحو تحقيق الأهداف ومؤيدة للسوق. ويواصل الاقتصاد العمل باستخدام إصلاحات اقتصادية مجزَّأة، تعوقها بقايا قوية من عهد عبد الناصر، مما أدى إلى نمط بطيء وغير متسق من التنفيذ.
وأدى هذا النهج المختلط إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما يفرض تحديات على المستثمرين المحليين والعالميين. وفي حين قد يتمكن المستثمرون من التنقل عبر عدم الاستقرار السياسي، فإن عدم اليقين في السياسة الاقتصادية يُعتبر بمثابة مثبط للشركات عن التوظيف والاستثمار والوصول إلى الأسواق. لذلك، فمن أجل معالجة التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد المصري، من الضروري تقييم ومعالجة المتطلبات الأساسية للاقتصاد السياسي، وليس التركيز فقط على أساسيات الاقتصاد الكلي. وبدون تعزيز أيديولوجية أكثر قوة مؤيدة للسوق، سواء داخل الحكومة أو بين عامة الناس، فستظل الإصلاحات الاقتصادية في مصر محاصرة في إطار حلقة من الركود لسنوات قادمة.