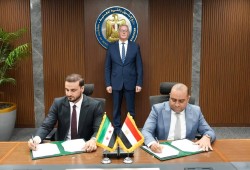تستعد مصر لاستقبال دفعة جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي مطلع عام 2026، وفق توقعات أوردها بنك ستاندرد تشارترد في تقرير اقتصادي حديث.
ورغم تقديم هذا التطور بوصفه “إشارة ثقة دولية” و”تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية”، إلا أن الواقع يفرض قراءة أكثر صرامة: هل يعكس هذا التمويل تعافيًا حقيقيًا للاقتصاد، أم أنه حلقة جديدة في سلسلة الاستدانة التي راكمتها حكومة الانقلاب، دون أن يلمس المواطن أي تحسن فعلي في مستوى معيشته؟
الخبر الذي تستقبله الحكومة بترحيب، يراه كثيرون دليلاً إضافيًا على فشل النموذج الاقتصادي القائم على القروض، وغياب أي رؤية إنتاجية تخرج البلاد من دوامة الاقتراض المشروط.
“تحسن المؤشرات” أم تجميل للأرقام؟
يعزو بنك ستاندرد تشارترد توقعه إلى ما وصفه بتحسن قوي في أداء الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي. لكن هذا “التحسن” لا يتجاوز كونه استقرارًا هشًا ناتجًا عن تدفقات مؤقتة من القروض والاستثمارات الساخنة، وليس نتيجة نمو حقيقي في الإنتاج أو الصناعة أو الصادرات.
تحسن الجنيه أمام الدولار خلال فترات محدودة لم يكن مدفوعًا بقوة الاقتصاد، بل بتدخلات نقدية وضخ أموال خارجية ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية أنهكت النشاط الاقتصادي. كما أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، الذي تتباهى به الحكومة، يعتمد في جزء كبير منه على الديون والالتزامات، لا على موارد ذاتية مستدامة.
بعبارة أوضح، حكومة الانقلاب لم تُصلح الخلل الهيكلي في الاقتصاد، بل أدارت الأزمة عبر المسكنات: قروض جديدة لسداد قروض قديمة، مع تقديم أرقام “مُحسّنة” للأسواق الدولية، بينما يزداد الضغط على الداخل.
قرض جديد… وديون أعمق وشروط أقسى
الدفعة المتوقعة بقيمة 2.5 مليار دولار ستُضاف إلى رصيد ديون مصر الخارجية، التي تجاوزت مستويات غير مسبوقة. ورغم الحديث الرسمي عن أن القرض سيساعد في تغطية الالتزامات الخارجية وسد فجوة العملة الأجنبية، فإن الحقيقة أن هذه الأموال لن تُوجَّه إلى مشروعات إنتاجية، بل ستُستخدم في الغالب لسداد أقساط ديون قائمة وتمويل الواردات الأساسية.
الأخطر من ذلك أن قروض صندوق النقد لا تأتي بلا ثمن. فكل دفعة جديدة تعني مزيدًا من الشروط القاسية: رفع الدعم، تقليص الإنفاق الاجتماعي، زيادة الضرائب غير المباشرة، وترك الأسعار “لقوى السوق”. وهي سياسات أثبتت فشلها في حماية الفئات الفقيرة، بل ساهمت في توسيع دائرة الفقر وإضعاف الطبقة الوسطى.
وبينما تتحدث الحكومة عن “استقرار السيولة”، يعيش المواطن واقعًا مختلفًا: أسعار لا تتوقف عن الارتفاع، خدمات تتراجع، ودخول ثابتة تآكلت بفعل التضخم. القرض، في هذه المعادلة، لا يُنقذ الاقتصاد بقدر ما يُنقذ السلطة من أزمات السيولة قصيرة الأجل.
المواطن خارج الحسابات… والاقتصاد في مهب القرارات السياسية
تشير التوقعات إلى تحسن نسبي في قطاعات مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إضافة إلى إقبال المستثمرين على أذون الخزانة. غير أن هذه المؤشرات لا تعكس تحسنًا في حياة المواطنين، بقدر ما تعكس قدرة الحكومة على جذب أموال قصيرة الأجل مقابل فوائد مرتفعة، تُضاف لاحقًا إلى أعباء الموازنة.
ارتفاع الطلب على أدوات الدين المحلي ليس شهادة ثقة بقدر ما هو استغلال لأسعار الفائدة المرتفعة التي تدفعها الدولة. وفي النهاية، تُموَّل هذه الفوائد من جيوب المواطنين، عبر الضرائب ورفع أسعار الخدمات.
حكومة الانقلاب تُصر على تسويق القرض بوصفه “خطوة إيجابية”، لكنها تتجنب السؤال الجوهري: متى يشعر المواطن بثمار هذا “التحسن”؟ ومتى يتوقف تحميله فاتورة سياسات اقتصادية فاشلة، صُممت لإرضاء الدائنين لا لحماية المجتمع؟
وفي النهاية ومع وصول 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مطلع 2026 قد يمنح الحكومة متنفسًا ماليًا مؤقتًا، لكنه لا يمثل حلًا حقيقيًا لأزمة الاقتصاد المصري. فالمشكلة لم تكن يومًا نقص القروض، بل غياب الرؤية، وسوء الأولويات، وهيمنة القرار السياسي على الاقتصاد.
وبينما تتكدس الديون وتتحسن الأرقام على الورق، يظل المواطن المصري الخاسر الأكبر، يدفع ثمن “الإصلاح” دون أن يرى إصلاحًا، ويتحمل تبعات الاستقرار المزعوم بينما يزداد واقعه قسوة يومًا بعد يوم.