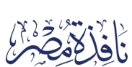د.خالد أبوشادي، عبر فيسبوك:
1. ﴿حجرا محجورا﴾: أي حرام محرَّما، والقائلون الملائكة، فيكون المعنى: تقول الملائكة للكفار حجرا محجورا. أى: حراما محرما أن تكون لكم اليوم بشرى، أو أن يغفر الله لكم، أو يدخلكم جنته.
أو القائل الكفار: «حجرا محجورا» أى: حراما محرما عليكم أن تنزلوا بنا العذاب، فنحن لم نرتكب ما نستحق بسببه العذاب.
2. ﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا﴾: قال ابن المبارك: «كل عمل صالح لا يراد به وجه الله».
3. ﴿أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا﴾: استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن حساب أهل الجنة يسير، وأنه ينتهي في نصف نهار ، ووجه ذلك أن قوله : مقيلا : أي مكان قيلولة وهي الاستراحة في نصف النهار.
4. ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: 30]: كل من هجر القرآن بأي نوع من الهجر: سواء بتلاوته، أم بتدبره، أم بالعمل به، أم بتحكيمه والتحاكم إليه.
5. ﴿يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾: هذا قول نبيكم يشتكيكم إلى ربكم، فما ردُّكم على هذه الشكوى؟!
6. { الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلا }: في الصحيح، عن أنس: أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال: "إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يُمشِيَه على وجهه يوم القيامة".
7. ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾: قال ابن القيم: هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه، فالمؤمن دائماً مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه، وهذا المعنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه، والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه، وعبارات السلف على هذا تدور.
8. ﴿وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَها، بَلْ كانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً﴾: المراد بالقرية هنا قرية سدوم وهي أكبر قرى قوم لوط، والتي جعل الله عاليها سافلها، والمراد بما أمطرت به الحجارة التي أنزلها الله عليها.
9. ﴿إِنْ كادَ لَيُضِلُّنا عَنْ آلِهَتِنا لَوْلا أَنْ صَبَرْنا عَلَيْها﴾: عجيبٌ تواصي الكفار بالصبر على الباطل وجلدهم في الذود عنه، مع ما نرى من جزع بعض أهل الحق وتخاذلهم عن نصرة الحق.
10. ﴿فلا تُطِعْ الكافِرين﴾: قال الألوسي: السورة مكية ولم يشرع في مكة الجهاد بالسيف، ومع هذا لا يخفى ما فيه، ويستدل بالآية على الوجه المأثور على عظم جهاد العلماء لأعداء الدين بما يوردون عليهم من الأدلة وأوفرهم حظا المجاهدون بالقرآن منهم.
11. ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾: قال عمر بن الخطاب والحسن وابن عباس: معناه لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ ما فاته من الخير والصلاة ونحوه في أحدهما، فيستدركه في الذي يليه.
12. ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾: قال الرازي: «الأصح أن اللغو كل ما يجب أن يلغى ويترك، ومنهم من فسر اللغو بكل ما ليس بطاعة، وهو ضعيف لأن المباحات لا تعد لغوا فقوله: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ ﴾ أي بأهل اللغو».
13. ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾: قدَّم السجود على القيام مع أن القيام يقع قبله إشارة إلى الاهتمام بالسجود، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وقال ﴿سُجَّدًا﴾ ولم يقل ساجدين للمبالغة في كثرة سجودهم.
14. (وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا) وقع الإخبار بـ (إِمَامًا) وهو مفرد مع أن حقه من حيث الظاهر أن يكون واجعلنا للمتقين أئمة؛ للإشارة بأن يكون كلُّ واحد منهم إماماً يُقتدى به.
15. ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾: قال ابن كثير:
«وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانها، فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم، فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل». لكنه نهج الطغاة في كل عصر.
16. ﴿وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾: القسم تعظيم، والتعظيم فيه تسوية بين المقسَم به والله رب العالمين. قال البقاعي: «فكل من حلف بغير الله، كأن يقول: وحياة فلان، وحق رأسه، ونحو ذلك، فهو تابع لهذه الجاهلية ».
17. ﴿وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ﴾: من الشرك الحلِف بغير الله سبحانه كما رواه أحمد وأبو داود عنه ﷺ أنه قال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك».
18. ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت. كما ثبت عن النبيّ ﷺ «أنه قال له رجلٌ: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندًّا؟ قل: ما شاء الله وحده».
19. ﴿لا ضير إِنَّا إلى رَبّنَا مُنقَلِبُونَ﴾: لا يضرنا إيذاؤكم لأن مرجعنا إلى الله، وهو يجزينا على إيماننا أتم الجزاء وأوسع العطاء.. لاحظوا: ثمرة إيمان ساعة!
20. ﴿وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾: قال البغوي: «أضاف المرض إلى نفسه وإن كان المرض والشفاء كله من الله، استعمالا لحسن الأدب كما قال الخضر: ﴿فأردت أن أعيبها﴾ [الكهف: 79] ، وقال: ﴿فأراد ربك أن يبلغا أشدهما﴾ [الكهف: 82]».
21. ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾: قال ابن عطية: «ولسان الصدق في الآخرين هو الثناء وخلد المكانة بإجماع من المفسرين».
22. ﴿إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾: لم خصَّ الله القلب بالذكر؟ لأنه الملك الذي إذا سلم سلمت الجوارح، وإذا فسد فسدت سائر الجوارح.
23. ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: دخلوا النار حين سوَّوا بالله غيره، فالمطلوب منك حتى تدخل الجنة أن يكون الله أكبر وأعظم في صدرك من كل شيء.
24. ﴿وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ﴾: وظيفة المجرمين في الدنيا أن يوهِنوا تعظيم أمر الله في قلبك؛ حتى يكون لتعظيم الخلق الغلبة عليه!
25. كان علي يقول: «عليكم بالإخوان فإنهم عدة الدنيا وعدة الآخرة، ألا تسمع إلى قول أهل النار: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ * وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾».
26. قال الزمخشري: «وجمع الشافع لكثرة الشافعين، ووحَّد الصديق لقلته».
27. ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ * وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾: قال قتادة: «يعلمون -والله -أن الصديق إذا كان صالحا نفع، وأن الحميم إذا كان صالحا شفع». من أعظم الآيات في الحث على الصحبة الصالحة!
28. ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾: قال ابن القيم: «وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم.
والأمر الجامع لذلك: أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلِم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله».
29. ﴿إِنِّي لعملكم من القالين﴾: قال ابن تيمية: «والقلي بغضه وهجره، والأنبياء أَوْلِيَاء الله يحبونَ مَا يحب الله، ويبغضون مَا يبغض».
30. ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مبين﴾: قال السعدي: «وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة، على أفضل الخلق، على أفضل بضعة فيه وهي قلبه، على أفضل أمة أخرجت للناس، بأفضل الألسنة وأفصحها، وأوسعها، وهو: اللسان العربي المبين».
31. ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾: قال القشيري: «انقطع إلينا، واعتصم بنا، وتوسَّل إلينا بنا، وكن على الدوام بنا، فإذا قلتَ فقل بنا، وإذا صُلْتَ فَصُلْ بنا، واشهد بقلبك- وهو في قبضتنا- تتحقق بأنك بنا ولنا».
32. لكن لماذا العزيز والرحيم؟! قال الألوسي: «فهو سبحانه يقهر من يعصيك منهم ومن غيرهم بعزته، وينصرك برحمته».
33. ﴿فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ﴾: كيف خوطب النبي ﷺ بهذا وهذا مستحيل في حقه؟! قال الألوسي: «تهييجا وحثا لازدياد الإخلاص، فهو كناية عن أخلِص في التوحيد حتى لا ترى معه عز وجل سواه.
وفيه لطف لسائر المكلفين ببيان أن الإشراك من القبح والسوء بحيث يُنهى عنه من لم يمكن صدوره، عنه فكيف بِمن عداه؟!».
34. ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ * إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾: ما معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قال القرطبي: «هذه سبيل العلماء بالله عز وجل أن يكونوا خائفين من معاصيهم وجلين، وهم أيضا لا يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط التوبة شي لم يأتوا به، فهم يخافون من المطالبة به».
35. ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ﴾: كم من نفوس تعرف الحق، لكن عنادها وكبرها يمنعها من الانقياد له.
36. ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾: ورِثه في النبوة لا في المال، فإن الأنبياء لا تورَث أموالهم، فاحرص على توريث دينك لأولادك، فهو وحده ما ينفعهم في الآخرة.
37. ﴿ولقد آتينا داود وسليمان (علما) وقالا (الحمد لله)﴾: إذا زادك الله علما، فازدد له شكرًا، فلا تتضاعف النعم ولا يُبارك فيها إلا بالشكر.
38. ﴿ولقد آتينا داوود وسليمان علما﴾: أوسع عطاء هو عطاء العلم، يؤتيك الله إياه، فتنفق منه على غيرك، فتكون متعلِّما ومعلِّما.
39. ﴿وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: قال السعدي: «عنوان سعادة العبد أن يكون شاكرا لله على نعمه الدنيوية والأخروية، وأن يرى جميع النعم من ربه، فلا يفخر بها ولا يعجب بها بل يرى أنها تستحق عليه شكرا كثيرا».
40. ﴿لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لايشعرو﴾: اعتذرت هذه النملة عن الخطأ قبل وقوعه، فليتنا نتعلم منها حسن الظن والتماس الأعذار.
41. يقول أهل البلاغة أن هذه النملة جمعت ثلاثة عشر أمرا:
أَحَسَّتْ : أحست بِوجودِ الخطر.
وبادرت: بادرت بإبلاغ النمل بما سيأتي.
ونادت: يا.
ونبهت: أيها.
وأمرت: ادخلوا.
ونهت: لا يحطمنكم.
وأكَّدت: نون التوكيد في يحطمنكم.
ونصحت: نصحت بنوع الفعل الواجب عمله.
وبالغت: يحطمنكم كلكم.
وبيَّنت: من الذي أتى بالخطر.
وأنذَرت: أنذرت النمل.
وأعذرت: وهم لا يشعرون.
ونفَت: لا يشعرون.
42. ﴿فتبسم ضاحكا من قولها﴾: قال الزجَّاج: «أكثر ضحك الأنبياء التبسم». اقتدِ بالأنبياء فأكثر من التبسم.
43. ﴿فتبسم ضاحكا من قولها﴾: التبسُّم ضحك أهل الوقار.
44. ﴿وتفقد الطير﴾: قال القرطبي: «في هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته، والمحافظة عليهم، ويرحم الله عمر فإنه كان على سيرته، قال: لو أن سخلة على شاطئ الفرات أخذها الذئب ليسأل عنها عمر، فما ظنك بوالٍ تذهب على يديه البلدان، وتضيع الرَّعِية ويضيع الرعيان».
45. ﴿لأعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لأذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾: لم يقسم على عذابه أو قتله إلا إذا لم يقدِّم عذرا واضحا لتخلفه، فهذا مقتضى العدل.
46. ﴿أحطت بما لم تحط به﴾: في حضرة الأنبياء وهم أعظم العظماء تمتلك الطيور الجرأة على إبداء الرأي وقول الحق.. حرية!
47. ﴿ أحطتُ بما لم تُحِطْ به ﴾: تفيد أنه قد يوجد من العلم عند الأصاغر ما لا يوجد عند الأكابر!
48. ﴿ أحطتُ بما لم تُحِطْ به ﴾: تعلموا الشجاعة في قول الحق من هدهد.
49. ﴿ألا يسجدوا لله﴾: طائر غير مكلف ينكر المنكر، ويتعجب بفطرته السليمة من عدم القيام بأمر الله، فبعض الحيوانات أعقل من بعض البشر.. اللهم اجعل أفئدتنا كأفئدة الطير.
50. ﴿وجدتُها وقومها يسجدونُ للشمس من دون الله﴾: غار الهدهد على محارم الله، فمتى نغار إذا انتهكت محارم الله!
51. كيف كافأ الله الهدهد.! قال القرطبي: نهى عن قتل الهدهد، لأنه كان دليل سليمان على الماء ورسوله إلى بلقيس. عن ابن عباس أن النبي ﷺ «نهى عن قتل أربع من الدواب النملة، والنحلة، والهدهد، والصَّرَد».
52. ﴿أَفْتُونِي فِي أَمْرِي﴾: قيل إنها أول من وضع المشورة.
53. ﴿أَفْتُونِي فِي أَمْرِي﴾: قال القشيري: «أخذت في المشاورة كما تقتضيه الحال في الأمور العظام، فإن الملك لا ينبغى أن يكون مستبدا برأيه، ويجب أن يكون له قوم من أهل الرأى والبصيرة».
54. ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾: تعلموا السياسة ولباقة الحديث حيث جمعت القادة واستشارتهم، وأعلمتهم أن هذه عادتها الدائمة، فطابت نفوسهم، وازدادت ثقتهم فيها.
55. ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾: هذا هو فن الحوار واستمالة القلوب لئلاَّ يخالفوها في الرَّأي والتدبير.
56. ﴿قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾: القوة مغرية والسلاح باطش! فقد أحست بلقيس من قادة الجيش الطيش والميل إلى الحرب والاستقواء بالسلاح، والميل عن الصواب، فشرعت في رد مقالتهم.
57. ﴿قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾: أرادوا نحن من أبناء الحرب لا من أبناء الرأي والمشورة، فميداننا ساحات القتال لا قاعات السياسة.
58. ﴿وكذلك يَفْعَلُونَ﴾: تصديقٌ لرأي بلقيس من جهة الله تبارك وتعالى، وهو إبراز لقيمة هذه المرأة ونضج رأيها.
59. ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾: قال قتادة: «رحمها الله ورضي عنها، ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها!! علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس». تهادوا تحابوا!
60. ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ﴾: قد تمنع الهدية حربا! قال ابن عباس: «قالت لقومها: إن قبِل الهدية فهو ملكٌ فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه».
61. ﴿قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلأ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا﴾: لم خصَّ العرش؟!
قال أبو جعفر الطبري: «وأوْلى الأقوال بالصواب في السبب الذي من أجله خصّ سليمان بسؤاله الملأ من جنده بإحضاره عرش هذه المرأة دون سائر ملكها عندنا، ليجعل ذلك حجة عليها في نبوته، ويُعرِّفها بذلك قدرة الله وعظيم شأنه، أنها خلَّفته في بيت في جوف أبيات، بعضها في جوف بعض، مغلق مقفل عليها، فأخرجه الله من ذلك كله، بغير فتح أغلاق وأقفال، حتى أوصله إلى وليِّه من خلقه، وسلَّمه إليه، فكان لها في ذلك أعظم حجة، على حقيقة ما دعاها إليه سليمان، وعلى صدق سليمان فيما أعلمها من نبوُّته».
62. ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾: دليل على أنه يتأتى بالعلم ما لا يتأتى بالقوة، وأن الحكمة مكتسبة لقوله: ﴿عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾، وهو طريق امتلاك القوة.
63. ﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾: الفارق بين الملوك الجهلة والملوك الشاكرين! قال السَّعْدِي: «أي ليختبرني بذلك، فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين، بل علِم أن ذلك اختبار من ربه فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة».
64. ﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾: لأن نفع شكره يعود إليه دنيويا بدوام العافية، وأخرويا بالأجر العظيم، وقد قيل: الشكر قيد النعم الموجودة، وصيد النعم المفقودة.
65. ﴿ لولا (تستغفرون) الله لعلكم (ترحمون) ﴾ استنزلوا رحمات الله بالاستغفار، وإذا كانت رحمة الله تُرتجى للكافر لو استغفر، فكيف بالمؤمن؟!
66. ﴿قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ﴾: أي تشاءمنا، والشؤم النحس. قال القرطبي: «ولا شيء أضرَّ بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطِّيَرة، ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاء، أو يدفع مقدورا فقد جهل».
67. وفي الحديث: «الطِّيَرَةُ شِرْكٌ»
68. (قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ): استعير اسم الطائر لما حل بهم من مصائب للمشاكلة في قولهم (اطيرنا)، ومخاطبة لهم بما يفهمون لإصلاح ما يعتقدون.
69. ﴿قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ الله بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾: لما جاءهم صالح عارضوه، فأصابهم قحْط شديد، وضنَّتْ السماء بالمطر، فقالوا أن صالح سبب القَحْط لا الذنب، فكانت هذه فتنتهم.
70. ﴿ومكروا مكرا﴾: قال ابن عاشور: «سمَّى الله تآمرهم مكرا لأنه كان تدبير ضر في خفاء. وأكد مكرهم بالمفعول المطلق للدلالة على قوته في جنس المكر، وتنوينه للتعظيم».
71. ﴿وَمَكَرْنا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ﴾: قال سيد قطب: «وأين مكرٌ من مكر؟ وأين تدبير من تدبير؟ وأين قوة من قوة؟ وكم ذا يخطىء الجبارون وينخدعون بما يملكون من قوة ومن حيلة، ويغفلون عن العين التي ترى ولا تغفل، والقوة التي تملك الأمر كله وتباغتهم من حيث لا يشعرون».
72. ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا﴾: قال الألوسي: «وفي هذه الآية دلالة على أن الظلم يكون سببا لخراب الدور، وروي عن ابن عباس أنه قال أجد في كتاب الله تعالى أن الظلم يخرب البيوت وتلا هذه الآية، وفي التوراة: ابن آدم .. لا تظلم يُخرَب بيتك، قيل: وهو إشارة إلى هلاك الظالم إذ خراب بيته عقب هلاكه».
الأربعاء 21 جمادى الأولى 1447 هـ - 12 نوفمبر 2025
أخبار النافذة
850 يومًا بلا إفراج واحد.. حين محكمة جنايات القاهرة ويُحتجز العدل في مصر!
رماد الثورة وفتوى التحالف.. تحولات إسلامية في المرآة الأمريكية!
معنى أن تكون "وطنيًّا" في أيامنا
“حد السيف”.. يوم أفشلت “القسام” أخطر عملية تسلل إسرائيلية إلى غزة
التكافل والتراحم وحل مشكلات المجتمع من صميم الدين: رؤية شرعية ودعوية في مستجدات الواقع
فيديو || لحظة تزوير داخل لجنة انتخابية بالإسكندرية في انتخابات النواب
السودان على شفا كارثة إنسانية: أكبر أزمة نزوح في العالم منذ إبريل 2023
أسباب احتقان الأنف وأفضل طرق العلاج